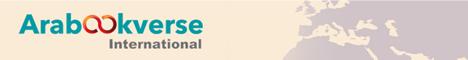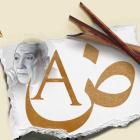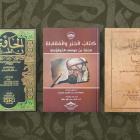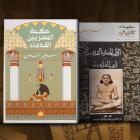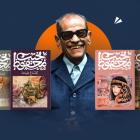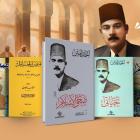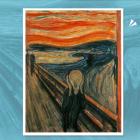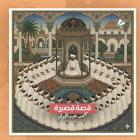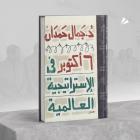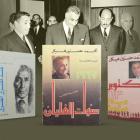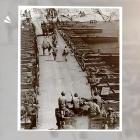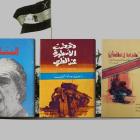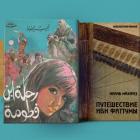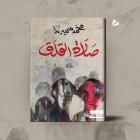معرفة
حسين مؤنس يكتب: محمد رؤية جديدة
ما حقيقة ادّعاءات كُتّاب السيرة عن فقر الرسول ﷺ؟ وكيف يكشف عناد أبي جهل، لمقاربته عمر النبي، جانبًا آخر من رفض قريش للإسلام؟.. رؤية جديدة لفهم بدايات الدعوة
 صورة تعبيرية (غلاف مقال للدكتور حسين مؤنس نُشِر بمجلة الهلال عن النبي ﷺ عام 1978)
صورة تعبيرية (غلاف مقال للدكتور حسين مؤنس نُشِر بمجلة الهلال عن النبي ﷺ عام 1978)
نُشِر هذا المقال لأول مرة بمجلة الهلال المصرية في أغسطس 1978م/ شعبان 1398هـ ضمن عدد تاريخي جاء تحت عنوان «محمد رؤية جديدة»، أصدره الدكتور حسين مؤنس، رئيس تحرير المجلة، وشارك فيه أكثر من 40 كاتبًا وأديبًا وعالمًا من ألمع كتاب مصر. (يتوفر نسخة صوتية من المقال في نهايته)
عاش الرسول الأعظم، صلى الله عليه وسلم، من بعثته إلى انتقاله للرفيق الأعلى ثلاثًا وعشرين سنة هجرية. ومن هذه الفترة القصيرة أنفق الرسول ثلاث عشرة سنة هجرية في مكة يعمل على هداية قوم قرّروا منذ البداية ألّا يدخلوا الإسلام، لأنهم كانوا أبعد ما يكونون عن إدراك شيء يسمّى «رسالة إلهية» أو «ديانة سماوية». كانت كل خطوط تفكيرهم قبلية، وكانت الدنيا عندهم تتمثّل في مراكزهم الاجتماعية ومكاسبهم المالية.
أبو جهل ورؤية جديدة لشخصيته
أبو جهل عاش ومات وهو يعتقد أنّ مسألة النبوة هذه حيلة ابتدَعها بنو هاشم وبنو عبد المطلب لكي يستعيدوا بها رياستهم التي فقدوها بعد وفاة عبد المطلب، وصارت إلى المجموعة التي كان هو من زعمائها: مجموعة بني عبد شمس، وبني مخزوم، وبني سهم، وبني مصيص، وبني تيم بن عبد مناة، وهي المجموعة التي تُعرف بـ«حلف لعقة الدم» أو «الأحلاف». هؤلاء كانوا قد سيطروا على أمور مكة تمامًا بأموالهم التي جمعوها بالغصب والغش، واستغلال حاجة المحتاج، وأكل أموال صغار التجار الذين كانوا يفدون على مكة.
وقد وجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ذات مرة أنّ واجبه يقضي بأن يخاطب أبا جهل ويأمره بردّ مالٍ لتاجر صغير وافد على المدينة أنكره عليه أبو جهل، فخاف أبو جهل وردّ المال.
وجدير بالذكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قوي البنية، فقد صرع أبا ركانة، الذي اشتهر بأنّه أقوى الرجال حينذاك، والذي لم يصرعه رجل قط. فتحدّاه الرسول فصارعه فصرعه ثلاثًا متتاليات. وقد كان خصومه، صلى الله عليه وسلم، يهابون لقاءه، مع أنّه كان من أحلم الناس وأبعدهم عن استعمال العنف.
ولكن ينبغي أن نذكر أنّ ذلك الرفض من جانب زعماء القرشيين للإسلام كان عنادًا ضد الحق، فقد كان أولئك الناس سادة المجتمع المكي الجاهلي يتمتعون بخيراته، ومهما كان فساده فقد كانوا سعداء فيه، بينما كانت الدعوة المحمدية تنادي بتغيير هذا المجتمع كلّه وتتّجه إلى هدمه وإقامة نظام جديد محله.
وهنا نفهم أبا جهل على ضوء جديد؛ فإنّ الرجل لم يكن غبيًا ولا إنسانًا بالغ الجلافة، وقد كان الرسول، صلى الله عليه وسلم، يرجو أن يعزّ الله الإسلام بأحد العمرين: عمر بن الخطاب أو أبو الحكم عمرو بن هشام، وهو أبو جهل.
الخصوم من جيل محمد وأنداده
وقد اختلفت مواقف خصوم الدعوة منها بحسب المصلحة والمزاج والعواطف، ولكنّهم اتفقوا في موقف الرفض الكامل لها رفضًا جامدًا بلا تفكير ولا تدبّر. فمنهم من رأى في دعوة محمد «حيلة سياسية» من بني هاشم وبني عبد المطلب كما ذكرنا. وهؤلاء كانوا فريقين:
-
فريق جيل محمد: أي الذين كانوا يقاربونه في السن، ومنهم عمه عبد العزى أبو لهب، وأبو الحكم عمرو بن هشام وهو أبو جهل، والحارث بن النضر بن كلدة، وعقبة بن أبي معيط، والأسود بن عبد يغوث. هؤلاء كانوا أشدّ الناس حقدًا على محمد، لأنّهم نفسوا عليه النبوة وخافوا أن يسودهم، ولهذا كان في تصرّفهم دائمًا حمق وحقد وحسد وبُعد عن العقل والحكمة.
-
ومن هؤلاء أيضًا ضرار بن الخطاب فارس قريش المشهور، وسهيل بن عمرو الذي تولّى الحوار مع الرسول عند الحديبية، وسفيان بن الحارث، وكانت تربطه بالرسول قرابة بعيدة، وكانا تَربَيَا وصاحبين في الصبا والشباب. فلمّا بُعث الرسول ملأت نفسه الغيرة وملكه الحسد، فأصبح من ألدّ أعداء الرسول وهجاه بشعر كثير.
- وكانت هناك طبقة «أصحاب الأسنان»: أي شيوخ قريش من القبائل المعادية لبني هاشم وبني عبد المطلب التي ذكرناها. وكان هؤلاء ينفرون من الإسلام نفورًا شديدًا، لأنّ انتشاره كان يهدّد مراكزهم الاجتماعية والمالية، غير أنّهم كانوا أميل إلى الهدوء في مواجهة الدعوة الإسلامية. وعلى رأس هؤلاء الوليد بن المغيرة، وعتبة بن أبي ربيعة، وأبو لهب، وأبو الحكم عمرو بن هشام وهو أبو جهل.
وقد قصد هؤلاء إلى أبي طالب، عمّ الرسول صلى الله عليه وسلم، راجين إيّاه أن يكفّ محمدًا عن دعوته. وقد وقعت بينهما وأمثالهما أربعة لقاءات مشهورة مع أبي طالب، تمسّك فيها بموقفه من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد رجاه أن يخفّف من الحملة على آلهة القرشيين وتسفيه أحلامهم وأحلام آبائهم. ولكن محمدًا رفض تمامًا ومضى في طريقه على ما هو معروف.
هؤلاء الخصوم أقاموا حول محمد، صلى الله عليه وسلم، سورًا من الحقد والحسد والكراهية، وحاربوا الدعوة ومن اتّبعها بكل سبيل. وانتهوا بعد عشر سنوات من العناد الأصم إلى إيقاف انتشارها في مكة، وكان ذلك قبيل خروج رسول الله إلى الطائف.
ووجه العبرة في ذلك الموقف كلّه هو موقف الثبات الذي وقفه الرسول، رغم العقبات التي كانت في طريقه، ورغم الأسوار العالية التي أقامها الخصوم حوله وحول أصحابه، ورغم العدوان على من استطاعوا إليه سبيلًا من ضعفاء المسلمين. وخلال هذه السنوات العشر لا نلحظ مرّة واحدة أنّه فقد صبره على العدوان عليه، أو أفلت منه زمام لسانه أو يده، وهي العبرة الكبرى التي نخرج بها من دراسة الفترة المكية من السيرة النبوية. لم يتسرّب إلى نفسه، صلى الله عليه وسلم، أدنى يأس، وهنا نأخذ أوّل صور الرؤية الجديدة للسيرة النبوية الشريفة.
الرؤية الجديدة للسيرة النبوية
ذلك أنّ حياة محمد، صلى الله عليه وسلم، إلى جانب جمالها وجلالها، كانت في الوقت نفسه رمزًا وعظةً وعبرةً تنفع المسلمين طوال تاريخهم لو أنّهم تدبّروها. ولقد كان الله سبحانه وتعالى قادرًا على أن ينصر الدعوة نصرًا مؤزرًا في الأسابيع الأولى لنزول الوحي، فيؤمن أهل مكة جميعًا، ثم يتّفق العرب على الدخول في الإسلام. ولكنّ الله تعالى عهد بالرسالة إلى الرسول، وتركه يخوض معركته مع البشر، لكي يتعلّم الناس كيف يخوضون معاركهم، وكيف يثبتون على مبادئهم فلا يتحوّلون عنها قيد شعرة، وكيف يعاملون الخصوم بالصبر والأناة والحلم وحسن الخلق والحجّة البالغة، وكيف يواجهون العقبات بقوّة العزيمة وعمق الإيمان وثبات القلوب.
وفي تقدير الله عزّ وجلّ أنّ أمّة الإسلام ستلقى في تاريخها بعد محمد عقبات مشابهة لما واجه الرسول، وستجد نفسها في المواقف ذاتها. وأنّ السيرة النبوية ينبغي أن تكون لذلك خير معين لها على النصر والخروج من الأزمات. ولو نظرتَ في أحوال العرب والمسلمين اليوم وما يواجهونه من ظروف قاسية، وحاولت أن تبحث لهم عن طريق يفضي بهم إلى السلامة من هذه الظروف، فإنّك ستجد هذا الطريق قطعًا في الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن رأيي أن نقرأ السيرة اليوم في مصادرها الأولى، أي دون أن يجري فيها عبد الملك بن هشام قلمه فيترك ما لا يرضيه ويثبت ما شاء مما انتهى إليه حديثه من رواة متأخرين. فإنّ ابن هشام أدخل تغييرات نعتبرها كبيرة، بينما نحن نريدها كما رواها أوائل الرواة: عروة بن الزبير، وأبان بن عثمان، وموسى بن عقبة، وعبيد بن شُرَيّة، ثم ابن إسحاق، والبلاذري، والواقدي، وابن سعد في طبقاته.
ونضيف هنا أنّ ابن عبد البر النَّمَري بدأ كتابه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»، وهو مجموع تراجم الصحابة، بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجزة ولكنها حافلة بالفوائد التي لا نجدها عند غيره. لأنّ ابن عبد البر، مثله في ذلك مثل ابن حزم، كان ينقل عن أصول اختفت ولم نعثر عليها إلى الآن…
فلنقرأ السيرة في هذه الأصول، فستتجلّى لنا في ظروفنا هذه عن نور جديد، وسنعرف محمدًا، صلوات الله عليه، في ضوء جديد، وسنرى إدراكًا جديدًا يعيننا على المسير في طريقنا اليوم. ولكن هذا يقتضي منّا أن نفهم السيرة فهمًا جديدًا.
لقد تعوّد الرواة والمؤرخون القدامى أن يسردوا سيرة النبي سردًا مرسلًا دون تقسيم أو بيان للمعنى الذي يستتر وراء كل حلقة من حلقاتها. والسيرة النبوية ليست مجرّد سرد لأحداث حياة النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنما حلقاتها عظات ودروس وعِبَر. وإذا قرأها الإنسان دون أن ينتبه إلى ذلك فاتته حكمة السيرة كلها. ولا أقصد تلك الأحداث القصيرة التي تعوّد خطباء الجمعة أن يردّدوها على مسامعنا للاستشهاد بها على صدق ما يريدون قوله في خطبهم التقليدية، وإنما أقصد المراحل الفاصلة في هذه السيرة التي تُعَدّ أمثلة لما سيمرّ على الأمة من أزمات. فإذا نحن وعينا حكمتها في السيرة، نفعنا هذا الوعي في السير بأمتنا الإسلامية في ظروفها وما ستتعرض له من ابتلاءات في طريق التوفيق والسلام والرخاء.
الأنساب الأربعة المؤثرة في تكوين مكة
خذ مثلًا عمود النسب النبوي، لقد حفظناه مذ كنا صغارًا، وردّده كُتّاب السيرة مرة بعد مرة. ولكن هل وعى أحد منّا موضع العبرة فيه؟ سأقف منه عند أربعة أسماء لها أثر بعيد في تكوين محمد وتهيئة الظروف في مكة على النحو الذي وجدناها عليه عند ظهور الإسلام. هؤلاء الأربعة هم: قصي، وعبد مناف، وهاشم، وعبد المطلب.
-
قصي بن كلاب: رجل الدولة والسياسة والحرب، الذي تزعم قريشًا وجمع بطونها، وقادها في السيطرة على مكة وسيادتها. وهو الذي وضع لهذه القبيلة نظامها المحكم الذي جعلها تصلح لمكانة خدمة البيت الحرام. قصي هو الذي جعل القرشيين حَضَرًا دون أن يفقدوا أحسن خصائص البداوة، وهي حقيقة مكّنت قريشًا من سيادة العرب جميعًا بدوًا وحضرًا، ومكّنت رجالها فيما بعد من القيام بالجانب الأكبر من مسؤوليات فتوح الإسلام وإقامة دولته.
-
عبد مناف بن قصي: رجل سياسة وتدبير، وهو الذي عقد الأحلاف بين قريش والقبائل الضاربة في منطقة مكة والحجاز – وخزاعة بخاصة – وأكّد رئاسة قريش في الحجاز. وقد انتفع الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالحلف مع خزاعة انتفاعًا عظيمًا.
-
هاشم بن عبد مناف: رجل أعمال وتاجر موهوب، وهو واضع الأساس للقوة التجارية التي وصلت إليها مكة. هو الذي عقد «الإيلاف» مع القبائل النازلة على طرق التجارة إلى الشام واليمن والعراق، و«إيلاف قريش» المذكور في القرآن هو مجموعة المعاهدات التجارية التي عقدتها مع تلك القبائل لتأمين رحلة الشتاء والصيف.
-
عبد المطلب بن هاشم: جدّ الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكان رجل دين وعقيدة، أقرب إلى الكهان. وهو الذي جعل الكعبة مركزًا للوثنية العربية، وجعل القبائل تضع نماذج من تماثيل معبوداتها حول الكعبة، فأصبحت مكة محجّ العرب أجمعين. كما رتّب مراسم الحج عند الجاهليين. وعن طريق الحج والتجارة والسياسة الذكية التي اتبعها، وصلت مكة إلى ذروة مجدها قبل الإسلام، وأصبحت قريش – على صِغَرها – أقوى قبائل الجزيرة وأشهرها وأغناها وأوفرها علمًا بالدنيا وبالناس.
ادعاءات فقر الرسول ﷺ!
وفي هذه الفترة، وفي أواخر أيام عبد المطلب، وُلد الرسول، صلى الله عليه وسلم. وُلد في بلدة عامرة بالنشاط والحيوية والثروة، وُلد في بيئة راضية متسعة الأفق. كل هذا يعطينا فكرة عن البيئة الحضارية والاجتماعية التي وُلد ونشأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد جرت عادة المؤرخين أن يبالغوا في تصوير سوء الظروف التي أحاطت بمحمد، صلى الله عليه وسلم، في طفولته وصباه. فصوّروه فقيرًا محتاجًا، وما كان الرسول في يوم من أيام حياته فقيرًا ولا محتاجًا. وإنما نعتمد في تصوير أحواله، صلى الله عليه وسلم، ما في طفولته وصباه وشبابه الباكر، قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى مخاطبًا رسوله الكريم:
﴿ألم يجدك يتيمًا فآوى * ووجدك ضالًّا فهدى * ووجدك عائلًا فأغنى﴾.
أي أنّه كان يتيمًا فآواه جدّه ثم عمّه، ووجده ضالًّا فهداه وحماه من الضلال والموبقات وأعدّه للرسالة الكريمة، ووجده عائلًا فأغناه بالتجارة.
وقد كان رسول الله في شبابه، وقبل زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها، تاجرًا ناجحًا ميسور الحال. ولهذا عهدت إليه في تولّي تجارتها، فزاد فيها بأمانته وخبرته. وبعد زواجه منها لم يعش على مالها، وإنما ظلّ يعمل في التجارة على طريقة كبار المكيين. ومن غريب ما نقرأ في «دائرة المعارف البريطانية» في مادة «محمد» أنّه كان صاحب دكّان! وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو بعدها بصاحب دكّان قط. وإنما كان كبار تجار مكة، ومنهم الرسول الكريم، يحتفظون بمتاجرهم في بيوتهم، ويتفاوضون في البيع والشراء إمّا في البيوت أو في الندوات أو المجالس حول الكعبة، وهناك تتم الصفقات.
وفي الرؤية الجديدة للسيرة النبوية الشريفة نقسم الفترة المكية من حياة الرسول بعد البعثة إلى ثلاث فترات، لكل منها عبرتها بالنسبة للمسلمين في كل زمان ومكان:
-
الفترة الأولى: ومدتها تُقدَّر بحوالي عامين، تبدأ من البعثة وتنتهي بدخول الرسول بيت الأرقم ودعوته فيه.
-
الفترة الثانية: وهي فترة بيت الأرقم، ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بعد إسلام عمر بقليل. ويذهب الكثيرون إلى أنّ عمر دخل الإسلام في العام الثالث للبعثة، ولكن التحقيق الدقيق دلّ على أنّ ذلك كان في العام الخامس للبعثة، أما الذي أسلم في العام الثالث فكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.
-
الفترة الثالثة: وهي فترة الدعوة العلنية والصراع مع قريش، وقد دامت ثماني سنوات، من الخروج من بيت الأرقم إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة.
خلال الفترة الأولى من الحقبة المكية، والتي دامت حوالي سنتين كما قلنا، تكوَّنت حول الرسول قلّة قليلة آمنت به، في مقدمتها السيدة خديجة رضوان الله عليها، وهي أول من آمن بالرسول الكريم، ثم علي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وأبو بكر الصديق. وممّن آمن في هذه الفترة بلال الحبشي، وخباب بن الأرت، وعمّار بن ياسر، ونفر من ضعفاء الناس.
وكان محمد يجتمع بالمسلمين الأوائل عند الكعبة ليعرّفهم ما ينزل عليه من آي القرآن المجيد، ويشرح لهم قواعد الإسلام. وكان هؤلاء المؤمنون القلائل يلتفون حوله ويقرؤون القرآن بصوت عالٍ، فانفَتَّ قريش من ذلك، لأنّهم كانوا يرون أنّ أولئك المستضعفين ليسوا أهلًا للجلوس إلى جوارهم عند الكعبة.
ولم يكن يضيرهم في أوّل الأمر أن يبشّر محمد بدين جديد، لأنّ مسائل الدين لم تكن تهمّهم كثيرًا ما دام محمد لم يذكر آلهتهم أو آباءهم بسوء. ولكن كبرياء الجاهليين أبى عليهم أن يقبلوا هذا النفر من صغار الناس إلى جوارهم في مجلسهم عند الكعبة.
ولم يكن الإسلام قد سُمّي باسمه بعد، فكان الناس يقولون: «إنّ فلانًا قد صبأ»، أي ترك عبادة الأوثان. أو يقولون: «دخل فيما يدعو إليه». وكان بعض القرشيين لا يصدقون أنّ الوحي يتنزّل على الرسول، صلى الله عليه وسلم، ويقولون: «غلام بني عبد المطلب يزعم أنّه يكلّم السماء».
وكانت العبادات صلاتين في الصباح والمساء: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾، مع استحسان الصلاة في الفجر: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. والصلاة بمعناها الأول – على ما هو معروف – كانت طلب الرحمة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.
دار الأرقم وبداية التنظيم السري للدعوة
وقد أحسّ الرسول الكريم أنّ نفرًا من الراغبين في الدخول في الإسلام يخشون القرشيين، كما وجد أنّه لا يستطيع أن يجتمع بأصحابه ويقرئهم القرآن ويعلّمهم أصول الدين في هذا المكان العام، لأنّ الكثيرين من سفهاء مكة كانوا يقتربون من مجلسه ويضايقون أصحابه. فاستقرّ رأيه على أن ينتقل بأصحابه إلى مكان خاص مقفل بعيد عن أولئك السفهاء. وكان من أوائل المسلمين شاب يُسمّى الأرقم بن أبي الأرقم، يعيش مع أبيه في منزل واسع في الطريق إلى الصفا.
دعاه الأرقم إلى أن يتخذ هذا البيت دار لقاء مع أصحابه، فقبل الرسول، وانتقل مع أصحابه إلى هذه الدار في أوائل السنة الثالثة للبعثة. وكانت دارًا مباركة على الدعوة؛ فقد أقبل الناس على الإسلام يدعو بعضهم بعضًا، وظهر من بين المسلمين دعاة ماهرون في شؤون الدعوة، أولهم أبو بكر الصديق، فقد أتى بنفر من أوائل المسلمين إلى دار الأرقم حيث أسلموا على يد الرسول، منهم: عثمان بن مظعون، ومصعب بن عمير، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص. وتزايد عدد المسلمين حتى بلغوا نحو ستين أو سبعين، كلهم كانوا يجتمعون في هذا البيت، فيقرأون القرآن، ويتحدّثون في شؤون العقيدة، ويجتمعون بنبيّهم الكريم، ويقيمون الصلوات جماعة.
وفي نهاية العام الأول للمقام في دار الأرقم أسلم حمزة بن عبد المطلب في خبر معروف. وقد تشجّع المسلمون بإسلامه، وخرجوا من دار الأرقم وتوجّهوا جماعة إلى الكعبة، وجلسوا جوارها يقرأون القرآن بصوت مرتفع. فاستاء القرشيون واشتَبكوا معهم في عراك عنيف، ضُرِب فيه أبو بكر ضربًا مبرّحًا حتى نُقل إلى داره لا يكاد يعي. فعاد المسلمون إلى الاجتماع في دار الأرقم كما يذكر ابن كثير.
وفي نهاية السنة الخامسة للبعثة كان إسلام عمر. بلغه أنّ أخته فاطمة قد أسلمت، وأنها تجتمع مع المسلمين في دار الأرقم وتقرأ القرآن مع زوجها. فذهب ليضربها، فلمّا كان بالباب سمع خباب بن الأرت يقرأ آيات من سورة طه، فرقّ قلبه للإسلام ودخل فأعلن إسلامه.
وقد فرح المسلمون فرحًا بالغًا بإسلام عمر، وقرّروا الخروج من بيت الأرقم والدعوة لدينهم علنًا، وخرجوا بالفعل يقودهم رسول الله وعمر بن الخطاب، وبدأ الصراع العنيف بين المسلمين والقرشيين. وهنا تبدأ الفترة الثالثة من فترات الحقبة المكية، ومدتها ثماني سنوات.
خلال هذه الحقبة وقعت حوادث جسام، استمرّ رسول الله يدعو جَهارًا غير هيّاب. كان القرآن يتنزّل عليه إرسالًا فيقرئه أصحابه، ويدعو إلى ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة، فيما كان المكيّون يقابلون دعوته بالعدوان والسفه والإنكار البالغ.
تحول ميزان الصراع!
وقد تزعم العداء للإسلام في أول سنوات هذه الفترة أبو جهل وأصحابه من أنداده ممّن كانوا في سنّ محمد. ووقع صدام شديد بين الجانبين، فانزعج لذلك كبار السنّ من القرشيين، وأسرع من الطائف عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة ومن في طبقتهم، وتولّوا الصراع مع الإسلام بطريقة أهدأ وأميل إلى السياسة. كلّموا أبا طالب مرارًا، ودعا أبو طالب ابنَ أخيه محمّدًا بعد أن تكلّموا في أمره للمرّة الرابعة، وسأله أن يرضي القرشيين بشيء ويكفّ عن عيب آلهتهم وآبائهم. فرفض أن يقدّم أعداء الإسلام أيَّ تنازل، وقال حديثه المشهور:
«والله يا عمّ، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يُظهره الله أو أَهلك دونه».
وبعد أن يئس كبار المكيين من صرف الرسول الأكرم عن رسالته، بدأوا في اضطهاد المستضعفين من أصحابه، مثل: بلال الحبشي، وعمّار بن ياسر، وخباب بن الأرت. وخاف رسول الله على أصحابه من أذى كفار قريش، فنصح المضطهدين والضعفاء منهم بالهجرة إلى الحبشة ليعيشوا هناك في أمان على عقيدتهم حتى تنجلي هذه الغُمّة. وعلى الرغم من صعوبة الرحلة، فإن نحو أحد عشر رجلًا وأربع نساء من أصحابه تمكّنوا من الإبحار إلى الحبشة من فُرضة الشُّعيبة. وبعد ذلك هاجر إليها نحو سبعين من الصحابة والصحابيات، حيث استطاعوا أن يقوموا بعبادات دينهم في أمان، وأن يكسبوا عيشهم دون مشقة.
وبقي محمّد في مكة مع فئة قليلة من أصحابه، منهم أبو بكر، وعمر، وحمزة. واجتهد نفر من أصحابه ممّن أوسع الله عليهم في الرزق في استنقاذ المستضعفين من العذاب؛ فكانوا يشترون الأرقّاء من سادتهم ويعتقونهم لوجه الله، وكان أكثر من فعل ذلك أبو بكر وعثمان.
وحين رأى كفار قريش أنّ المسلمين متمسّكون بعقيدتهم، مستعدّون لتحمّل أنفَس التضحيات في سبيلها، أدركوا أنّ أمر الإسلام ليس بالهيّن، وأنّ عليهم أن يقوموا بكل ما يستطيعون ليوقفوا سير هذه العقيدة. ولكنهم لم يستطيعوا، فإن محمّدًا رسول الله والذين معه صمدوا صابرين على كل أذى. نعم، إن انتشار الدعوة تمهّل بعض الشيء، ولكن محمّدًا استمرّ يعمل في إيمان وثقة، غير هيّاب لكل ما عساه أن يصدر عن أعداء الدعوة. وكانت إلى جانبه تقف تلك الفئة القليلة المناضلة التي تكوّنت معه وربّاها بالأسوة الحسنة فأحسن تربيتها. وكان القرآن يتنزّل عليه مُنجَّمًا، فيقرؤه أصحابه ويحفظونه عنه، ويراجعون ما يحفظون منه معه.
وكانت تلك الجماعة، بما فيها من هاجر الحبشة، تتكوّن من ثلاث فئات:
-
فئة الكبار من القرشيين: من أهل الذكاء والمواهب والصلابة، دخلوا الدعوة عن إيمان صادق ونفوس مؤمنة لا تعرف الخوف، مثل: أبي بكر الصديق، وعليّ بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وأبي سلمة بن عبد الأسد، وعثمان بن عفّان، وعمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص. وكل واحد من هؤلاء سيصبح بطلًا من أبطال الإسلام، وعَلمًا من أعلام التاريخ العالمي.
-
فئة الشباب من أصاغر أبناء القرشيين: دخلوا الإسلام عن إيمان وحماس، ورغبة في أن يُظهروا ملكاتهم ويقوموا بشيء كبير. وكان المجتمع الجاهلي يترك الأبناء دون رسالة أو عمل ما دام الابن الأكبر يرث المركز والمال. ومن هؤلاء: مصعب بن عمير، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان بن مظعون، وغيرهم.
-
فئة المستضعفين: ممّن لم يكن لهم قبل الإسلام كيان ولا مكان في المجتمع، مثل: بلال بن رباح، وعمّار بن ياسر، وخباب بن الأرت، وعبد الله بن مسعود، وعامر بن فهيرة. هؤلاء أوجد لهم الإسلام كيانًا ومكانة.
وعلى الجملة، كانت الجماعة الإسلامية جماعة شابة، معظم من دخل فيها من الشباب. فقد كان محمّدٌ صلى الله عليه وسلم في الأربعين، وكان أبو بكر يصغره بسنتين. ولم يكن في الجماعة من يكبر محمّدًا إلا عُبيدة بن الحارث.
ثم لجأت قريش إلى العنف مع بني عبد المطلب جملةً لترغمهم على التخلّي عن محمّد، فكانت المقاطعة الكاملة. حُصر آل الرسول جميعًا في شِعب أبي طالب، ومُنع عنهم الطعام، وأُوقِف التعامل التجاري معهم، حتى جاعت أطفالهم وساءت حالهم، وأكلوا رؤوس أموالهم. واستمرّت المقاطعة عامين ونصفًا، ولم تنتهِ إلا بتدخّل نفرٍ من كبار القرشيين، على رأسهم المطعم بن جُبير، الذي مزّق صحيفة المقاطعة.
وخرج بنو هاشم وبنو عبد المطلب من سجنهم وقد أنهكتهم المحنة وأصابتهم الفاقة، لأن المقاطعة أوقفت كل تعاملاتهم التجارية. وخلال هذه الفترة تأثرت صحة خديجة رضي الله عنها وقد علت بها السن، وطال كفاحها وصبرها مع زوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فاعتلّت وماتت في السنة السابعة للبعثة. وبعدها بقليل تُوفّي أبو طالب عن سنّ عالية، بعد أن نصر ابن أخيه قدر ما استطاع، وإن لم يفتح الله قلبه للإيمان.
ووجد محمّدٌ نفسه أبًا دون زوج، وله ثلاث بنات صغيرات: رقيّة، وأم كلثوم، وفاطمة، فَعُنيت بهنّ ابنةُ عمّه أم هانئ. وفي بيتها كان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومعراجه إلى السماء حيث لقي الأنبياء والملائكة، واقترب من العرش فرأى من آيات ربّه الكبرى.
وحديث المعراج في ذاته آية من آيات السيرة المحمديّة؛ فقد شرح صدر رسول الله وثبّته وزاده إيمانًا وقوّةً، في وقتٍ أحاطت به فيه دوامات اليأس. ويصوّر لنا هذه الحالةَ الحديثُ الذي دار بينه وبين أم هانئ صبيحة الإسراء والمعراج، فقد قصّ عليها الخبر ففزعت، ثم سألته ألّا يُحدّث به الناس خشية أن يشكّ بعضهم. لكنه قال: «والله لأحدّثنّهموه».
وبالفعل أصبح فقصّ ما رأى، فانزعج ضعفاء الإيمان وانصرف بعضهم عن الإسلام، ولكن المؤمنين، وأولهم أبو بكر، صدّقوه. ومن يومها لُقّب بالصديق.
وكان لقصة المعراج أثرٌ بعيد في الآداب الشعبيّة العربيّة والأوروبيّة؛ فقد تناولت ألسنة الناس حديث ابن عباس عن عائشة في المعراج وطوروه، وجعلوا منه قصة طويلة حافلة بالعجائب، تُرجمت إلى اللغات الأوروبية، وظهرت آثارها في «الكوميديا الإلهية» لدانتي. وكان ذلك من حسن حظ الإسلام، لأن أولئك الشباب الذين تربّوا في مدرسة الرسول الأعظم امتدّت أعمارهم حتى أقاموا دولة الإسلام ونشروه في الخافقين.
وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع أساس الجماعة الإسلامية، فإنّ الصحابة هم الذين واصلوا تشييد البناء، وأعانهم على ذلك طول أعمار الكثيرين منهم بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى. وتلك حقيقة لها أهميتها في هذه الرؤية الجديدة للسيرة النبوية الكريمة.
بعد التحام المسلمين مع المشركين عقب الخروج من دار الأرقم، لم يعد هناك مجال للصلح. فأمّا المشركون فقد تضامّت صفوفهم وبذلوا أقصى الجهد لوقف انتشار الإسلام. وأمّا المسلمون، فهاجر معظمهم إلى الحبشة، وبقِيَ محمدٌ وصحابته القليلون يجاهدون للحفاظِ على دينهم. صحيح أنّ انتشار الإسلام في مكة تباطأ، ولكن الرسول فكر في ميدان آخر يفتحُه للدعوة الكبرى.
والشيء الذي تنفرد به الرسالة المحمدية عن غيرها من الرسالات السماوية يتمثل في قوله تعالى:
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.
فالمسلمون مطالبون بتحمل مسئوليتهم كاملة في نشر دعوة الله، كما تحمّلها رسولهم الكريم كاملة. وتلك ناحية من نواحي الجمال الفريد في السيرة، فإذا أدرك كل مسلم هذه الحقيقة أحسّ بمسئوليته إحساسًا كاملًا، وبذل أقصى الوسع في القيام بما يعهد به إليه. ولو أدرك المسلمون هذه الحقيقة لكانوا دون شكّ في مقدمة أهل الدنيا.
وقد كان يمكن لمحمد أن يقرّ مكانه في مكة ويكتفي بالقيام بصلواته وعباداته بعد أن وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه مع أهلها، ولكن هذه لم تكن نفس محمد ولا طريقته في العمل. أقفل الطريق في مكة، فبحث عن طريق آخر، فخرج إلى الطائف مع مولاه زيد بن حارثة، ولم يعد من الطائف بنتيجة؛ لأنّ أهلها من ثقيف كانوا أبعد ما يكونون عن التفكير في عقيدة أو دين. كانوا قومًا أصحاب إقطاع كبير غني بالزروع والخيرات.
ونفس الظروف التي قام فيها محمد بخروجه إلى الطائف تدعو إلى التأمل؛ فقد كان قد وصل إلى نهاية الطريق في مكة، وكان أبو لهب عبد العزى رأس بني عبد المطلب، ولم يظهر منه ما يدل على استعداده لحمايته. وعندما خرج محمد من مكة إلى الطائف، فقد حقّه في حماية قبيلته، فلم يستطع العودة إلى مكة إلّا في جوار المطعم بن جبير، الذي اشترط عليه ألّا يدعو داخل مكة، فاتجه نشاطه إلى الدعوة خارجها.
فهل أثّر ذلك في حماس محمد؟ لا نلمح لذلك أثرًا؛ فقد أخذ يدعو القبائل خارج مكة. كان يخرج كل يوم مع أبي بكر ليدعو ويعود بغير نتيجة، فلا يترك ذلك في نفسه يأسًا، بل يظل هو هو: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجاهد في سبيل دعوته، الصامد في طريقه، الباسل في مواجهة الصعاب. ثم بدأت بدايات اتصاله باليثربيين، وهذه عبرة ورؤية جديدة.
فإنّ اليثربيين لم يأتوا إلى الرسول يعلنون إسلامهم من تلقاء أنفسهم؛ بل كان رسول الله هو الذي ذهب إليهم. ما كان يسمع بقدوم وفد من خارج مكة حتى يخف إليه ويدعوه. وعندما جاء رسل الخزرج يطلبون حلف قريش بعد انتصار الأوس عليهم في بُعاث، أسرع إليهم الرسول، فلم يقبلوا منه، بل إنّ رئيسهم أساء في مقابلته ومجادلته. ثم جاء رسل الأوس، فتوجّه إليهم الرسول ودعاهم إلى الإسلام، وهنا بدأت بشريات الأمل؛ إذ استمعوا إليه وآمن منهم ستة نفر.
وفي المناسبة التالية قامت بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية التي تم الاتفاق فيها على هجرة الرسول إلى المدينة. رحّب اليثربيون بالرسول وبالمهاجرين معه، وذلك بعد الجهد الرائع الذي بذله مصعب بن عمير في الدعوة إلى الإسلام في المدينة. ثم كانت الهجرة… وبداية الفترة المدنية.
ونقف هنا في نهاية الفترة المكية لننظر إليها نظرة جديدة. إنها ثلاث عشرة سنة هجرية، إذا قرأت خبرها عند ابن هشام لم تجد إلا أخبار اليأس والمعاناة والآلام والتعذيب. ولكننا إذا سردناها كما هي، وجدناها مليئة بالأمل والنور وعوامل القوة والاستبشار. والرسول ﷺ في الشدائد، كان عظيمًا كما سيكون عظيمًا في أيام النصر وانتشار الدعوة في المدينة.
وهنا موضع الرؤية الجديدة التي نريد نقلها إلى القارئ: إنّ الشدائد تعين على تقدير مقاييس النصر والظفر، والعبرة بمعدن الإنسان والأمة. فمن يصبر للشدائد ويغالبها ولا يستسلم لها، خليق بأن يصل إلى النصر، وحقيق بأن يبلغ ما يريد. وهل كان قليلًا ما تحمّله الرسول أثناء الفترة المكية؟ وهل كان قليلًا ما أظهره من قوة وثبات وإصرار على الاستمرار في الدعوة حتى قيّض الله لها الأنصار؟!
ذلك ما نريد أن يفكر فيه كل قارئ… وذلك ما نريد لكل عربي أن يتأمله في هذا الظرف العصيب الذي نحن فيه اليوم.
وأختتم هذا القسم الأول من «الرؤية الجديدة» عن الفترة المكية بأن أورد توقيت حوادثها بالتاريخ الميلادي (إذ لم يكن التاريخ الهجري قد وُضع بعد)، وذلك على أساس جديد يختلف عن الأساس التقليدي:
-
سنة 610م: البعثة ونزول أوائل آيات القرآن الكريم.
-
سنة 611م: الجهر بالدعوة وظهور الدعوة العلنية في مكة.
-
سنة 612م: دخول دار الأرقم والدعوة فيها.
-
سنة 613م: إسلام حمزة، ومحاولة المسلمين الأولى الخروج من دار الأرقم والدعوة جهرًا، وضرب المشركين لهم عند الكعبة، وإصابة أبي بكر (رواية ابن كثير).
-
سنة 615م: إسلام عمر، والخروج من دار الأرقم، وبداية الصراع العلني مع المشركين، وإسراع ذوي الأسنان من الطائف إلى مكة (رواية الطبري عن عروة بن الزبير). ابتداء اضطهاد المستضعفين.
-
سنة 615م – أواخرها: الهجرة الأولى إلى الحبشة.
-
سنة 616م: الهجرة الثانية إلى الحبشة.
-
سنة 616م: حصار بني هاشم وبني عبد المطلب في شِعب أبي طالب.
-
سنة 619م: نهاية الحصار وخروج المسلمين من الشعب، وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، وفاة أبي طالب، الخروج إلى الطائف.
-
سنة 620م: اللقاء الأول بين الرسول وأهل يثرب.
-
سنة 621م: اللقاء الثاني مع اليثربيين وبيعة العقبة الأولى.
-
سنة 622م: بيعة العقبة الثانية.
-
سنة 622م: الهجرة إلى يثرب، بداية التاريخ الهجري.